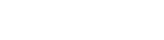خديجة زاز
1
2
3
في المغرب، حيث يسير المجتمع بخطى ثابتة نحو التحديث والانفتاح، لا يزال الجدل قائماً – وإن بخفوت – حول العلاقة بين الإنسان القروي والإنسان الحضري، وما إذا كانت النظرة الدونية للأول لا تزال تجد لنفسها موطئ قدم في المخيال الجمعي لبعض فئات المجتمع.
على امتداد السنوات الأخيرة، شهد المغرب تحولات بنيوية لافتة على المستوى الثقافي، التعليمي، والاقتصادي، رافقتها قفزات نوعية في الحضور الدولي للمغرب، سواء في المجالات الرياضية أو الدبلوماسية أو الفنية. ورغم هذه التحولات، يطرح سؤال مركزي نفسه بإلحاح: لماذا ما زال البعض يُفرّق – ولو ضمنيًا – بين من ينتمي إلى المجال القروي، ومن يعيش في المدن الكبرى؟
تاريخيًا، نشأ هذا التمييز من الفجوة التنموية التي طبعَت علاقة المركز بالأطراف. فالمجال الحضري ارتبط بالمؤسسات، بالبنى التحتية المتطورة، وبفرص التعليم والعمل، فيما ارتبط القروي بالحرمان والعزلة. غير أن هذه الصورة، رغم كونها كانت حقيقية في مراحل معينة، لم تعد تعكس الواقع المغربي الراهن.
لقد شهدت العديد من المناطق القروية بالمغرب تطورًا ملموسًا، سواء على مستوى البنية التحتية أو الخدمات الاجتماعية والتعليمية. كما أن أبناء هذه المناطق استطاعوا، عبر المثابرة والاجتهاد، أن يثبتوا كفاءتهم داخل المغرب وخارجه، في مواقع المسؤولية والبحث العلمي والإبداع.
ورغم كل هذه التحولات، تستمر بعض العقليات – عن وعي أو دون وعي – في إنتاج خطابات تمييزية، تتجلى في لغة يومية تُكرّس الفصل بين “القروي” و”المديني”، وتحمّله دلالات اجتماعية تقليدية تتراوح بين التهكم والتقليل. وهي مقاربات تختزل الإنسان في جغرافيا، وتتغاضى عن معايير أكثر عدالة وإنصافًا، كالقيم، والقدرة، والإرادة.
ما يثير الانتباه أكثر هو أن هذا التمييز، وإن كان أقل حدة مما مضى، يُعيد إلى الأذهان سيناريوهات التفرقة التي عرفتها مجتمعات أخرى، سواء على أسس عرقية أو طبقية أو ثقافية. فهل نحن أمام تكرار لنفس النسق، ولكن بلغة جديدة؟ وهل يمكن أن يتحوّل التفاوت المجالي إلى ذريعة لإعادة إنتاج أشكال من الهيمنة الرمزية؟
الإجابة تظل معلّقة بين ما هو قانوني وما هو ثقافي. ففي حين يكفل الدستور المغربي مبدأ المساواة بين جميع المواطنين، تظل الممارسة اليومية أحيانًا رهينة بتمثلات قديمة، لم يتم تفكيكها بعد بالشكل الكافي.
لذلك، فإن الرهان اليوم ليس فقط في تنمية العالم القروي ماديًا، بل في خلق وعي مجتمعي جديد، يتجاوز ثنائية القروي/المديني، نحو رؤية أفقية تنظر إلى الإنسان كمواطن كامل، بصرف النظر عن خلفيته الجغرافية. وهو رهان يتقاطع فيه دور الدولة مع الإعلام والمدرسة والمجتمع المدني، في معركة صامتة ولكن حاسمة ضد الصور النمطية.
التحولات المجتمعية لا تقاس فقط بما يتحقق من إنجازات في الخارج، بل أيضًا بما يُفكّك من أحكام مسبقة في الداخل. ومغرب الإنصاف والتنوع لن يكتمل إلا حين يتحرر من كل أشكال التصنيف.